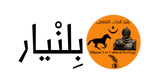مختارات من كتابات إلهامي

معارضة الشرع بالعقل تنزع الإيمان من القلب
أعظم الناس نفعا وفائدة أولئك الذين تحرروا من سطوة البيئة والزمن والثقافة الغالبة، فنافحوا عن الإسلام ودعوا إليه على ثقة وعلى بصيرة، أولئك هم الذروة حقا، وكتاباتهم هي أنفع الكتابات وأولاها بالدراسة والعناية! فرغت هذه الأيام من قراءة كتابين بذل فيهما أصحابهما جهدا عظيما، حافلا بالتكلف والتعسف، واتخاذ منهج وقواعد من لوازمها أن تهدم الدين ومصادره وعلمائه بالجملة، ما حملهما على هذا كله إلا شعورهما بالحرج من أن النبي تزوج عائشة وهي في التاسعة من عمرها!
فلأجل أن ينجو من الحرج الذي تفرضه الثقافة المعاصرة التي لا تحبذ زواج الفتاة قبل العشرين، أسهر ليله وأهلك عقله وخان الأمانة العلمية لكي يبرئ النبي أمام هذه الثقافة مما تصور هو أنه يسيء إليه!! وإلى وقت قريب في أيامنا هذه، لم يكن زواج الشيخ بالفتاة مما يعيبه ولا يعيبها، ولو أنه كان عيبا لكان أسرع الناس إلى معايرته بها كفار قريش في أيامه، وما ورد هذا عنهم لأنه لم يكن عيبا.. بل أزيد فأقول: لو اجتمع كفار قريش ومن قبلهم ومن بعدهم حتى يومنا هذا على أنه عيب، ثم فعله النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه، لكان فعل النبي هو الحق وهو الحسن وكل ما عداه هو الباطل وهو القبيح.. فنحن نأخذ معارفنا ومعاييرنا في الحكم مما جاء به الوحي لا مما يتعارف عليه البشر في زمان ما أو مكان ما. فلو أن أصحابنا يتخلصون من الحرج أولا، ويقفون موقف الثقة من دينهم والاتباع له بالرضا والتسليم، ما كانوا ليبذلوا كل هذا الجهد.. والأخطر من خسارة هذا الجهد هو أثر ذلك على الإيمان، فالحال -كما قال ابن تيمية بحق- أن “من تعود معارضة الشرع بعقلة لم يستقر في قلبه الإيمان”..
فلا يزال المرء يتحرج من الدين فيسعى في أن ينفي عنه ما لا يوافق الذوق المعاصر، ثم أن يدخل فيه ما يلائم الذوق المعاصر.. حتى يكثر الحرج فيدخل في معركة مع مجمل الفقه والفقهاء، ومجمل الحديث والمحدثين، ثم مجمل الوحي فيهرع إلى التأويل والتحريف، ويتمسك بدعاوى التجديد والقراءات الجديدة.. حتى لا يبقى في قلبه إسلام يؤمن به ويحبه ويوالي عليه ويعادي.
وملاحظة أخرى: مع أن المشرق مليء بالعلمانية والشر والمفسدين والمنهزمين، إلا أن تفشي ظاهرة الانهزام أمام الغرب -لا سيما في بيئة طلاب العلم والإسلاميين- أكثر وأخطر، فيما أرى، والله أعلم.
الثقافة الغالبة وسطوتها
أشعر بثقل الثقافة الغالبة وسطوتها حين أكتب شيئا لا تدعمه الأحداث المنظورة الحاضرة.. مهما تفنن المرء في إيجاد المداخل ومحاولة الشرح والتبسيط وجمع الأدلة فإنه كالذي يحاول السير في الحائط، ومهما حاول المرء ضبط العبارة وتدقيقها دخل إليه المعلقون بما ينبئ أنهم لم يفهموها أو فهموها ولم يقتنعوا (وهذا بخلاف من يمارسون السب والهجوم على الدوام)
حتى إذا جاء حدثٌ ما انقشع كل ذلك الوهم، ورأيت الذي كنت أعاني في كتابته مكتوبا منتشرا على ألسنة كثيرين، كما أن استقبال الناس له يبدو سلسا يسيرا مقبولا غير مستنكر!
كل ما كنت تكتبه عن الديمقراطية الأمريكية وأنها ظالمة وأنها لعبة بين متنفذين كان يبدو غريبا عجيبا مستنكرا، حتى لو كان بناء المقال كله من كتابات الغربيين والأمريكان أنفسهم.. فما هو إلا أن يقع حادث كالذي يحدث الآن إلا وترى الجميع متقبلا ومتفهما للحديث عن عيوب الديمقراطية الأمريكية وكونها غطاء مزخرفا لواقع شديد الظلم والقسوة.
تذكر في أيام ثورة يناير -مثلا- لقد كانت فكرة مواجهة الدولة والتصدي لها وحتى رد الاعتداء على الجندي الغلبان مسألة تكاد تكون محسومة لا نقاش فيها، يكتبها اليساري والليبرالي والإسلامي وحتى غير ذي التوجه والتصنيف.. مسألة رد الاعتداء والدفاع عن النفس والحق في مواجهة الدولة الظالمة كانت تبدو كبديهية..
حتى تفجير خط الغاز الذي يذهب لإسرائيل والأردن، كان عملا بطوليا تتغزل فيه البنات على تويتر، ويتبارين في تمني الزواج من الملثم الذي يفجر خط الغاز.. الآن طبعا هذا الملثم هو إرهابي داعشي عنيف شنيع قبيح ودمه حلال وتعذيبه حلال وتصفيته حلال وهدم بيته حلال، وكل شيء حلال من أجل عيون الدولة والأمن القومي والجيش العظيم!
كثيرا ما تساءلت: إذا كان الأمر هكذا.. وإذا كانت فطرة الناس وعقولهم تختزن معاني الحق ولكنها تنتظر فرصة انقشاع السطوة لا أكثر.. فلماذا نمارس هذه الكتابة الثقيلة التي تصنفنا كمتطرفين وإرهابيين وتضع أسماءنا على قوائم الوصول والترقب والإرهاب و… إلخ! بل ويُهَدَّد بها أمن آبائنا وأمهاتنا ونحتار بها في البحث عن إقامة وموطن للعيش؟!
ألا يبدو الأسهل والأفضل حال للجميع أن نكف عن هذا الحديث الثقيل ذي التكاليف الباهظة، طالما أن الأحداث ستأتي بما ينسف الأوهام من العقول والقلوب؟!
ألا لو أنها مجرد حسبة الدنيا فلربما صحَّ هذا.. إلا أن حسبة الدين تكلفنا بقول الحق مهما كان رد فعل الناس! لكن.. ألا يُحتمَل أن هذا الكلام نفسه في لحظات الثقل والضرورة هو من أسباب انقشاع الوهم، ومن أسباب صحوة الناس عند نزول الحدث وزوال السطوة؟.. أليست سيرة المناضلين أنهم يغرسون، حتى لو أنهم لم يبلغوا الثمرة ولم يشهدوا الحصاد؟.. أليست الشعوب حين تنتصر على غالبيها وتعيد كتابة التاريخ ترفع من حقه الرفع وتخفض من حقه الخفض؟!.. أليس هذا مما يدل على أن الكلام وقت الضيق والتكاليف لم يذهب هدرا؟! ربما، لم أهتدِ إلى إجابة حاسمة عن هذا بعد؛ مع أني أشعر أن هذا المنطق مما يسلِّي به العاملون أنفسهم، وأراني أقرب إلى أن تأثير الحدث وزوال سطوة الغالب أقوى وأوسع من كل كلام قيل يوما ما..
على كل حال، لو صحَّ منا الإخلاص لله، فالأجر عنده لا يضيع، سواءٌ أثمر هذا الكلام أم لم يثمر.. وهنا يأتي الاختبار الأصعب: هل كنتَ مخلصا لله حقا؟! أم داخل الكلامَ شيء من رياء وعجب وحب مدح وحب شهرة وابتغاء مصلحة؟! تلك معركة قلبية ملتهبة، تضطرم فيها الغايات الظاهرة والخفية، لا ينجو منها أحد، وإذا كان رجل صحابي كبير من السابقين الأولين مثل ابن مسعود تمنى لو خلصت له سجدة واحدة.. فكيف يقول أمثالنا؟!
أزمتنا مع العلمانيين والليبراليين
ثمة أزمة متكررة بيننا وبين العلمانيين والليبراليين ومن يميل إليهم حين نتعرض لنقاش عن الفساد والمشكلات في مجتمعاتنا الإسلامية.
وهذه الأزمة نجعل النقاش كأنه حوار بين طرشان!!
من طغيان الحكام وفساد الحكومات حتى مشكلات المرأة والطفل.
خلاصة هذه الأزمة كالتالي: نحن نرى هذه المشكلات انحرافا عن الإسلام وهم يرونها انحرافا عن الليبرالية
فنحن نحاول العودة إلى الإسلام لحلها، وهم يحاولون سحبنا إلى التغريب لحلها.
وبينما نجد دعمنا في جماهير الأمة التي ما إن تتاح لها فرصة الاختيار إلا وتختار الإسلاميين (في الصناديق والعملية السياسية)
أو ترسل أبناءها إليهم (في الثورات التي تعسكرت أو مقاومة الاحتلال)..
يجدون هم دعمهم في ثقافة غالبة متفوقة لها حضورها الطاغي في مجالات السياسة والثقافة والاقتصاد والاجتماع.
لا أشك أن فيهم مخلصين ووطنيين ويعملون لصالح البلاد وأهلها.. وهؤلاء، نحن وهم، تحت القمع العام للحكومات نفسها، والتي هي صنيعة الأنظمة الغربية ووكلاءها!
فالواقع أن الغرب نفسه لا يسمح لنا بالتغرب على نحو ما هم فيه..
هو يسمح لنا بالانحلال الأخلاقي ويروج بيننا الفكرة العلمانية دون أن يسمح لنا بحرية الاختيار وامتلاك أدوات العلم والنهضة!
ولذلك كثيرا ما يثير إشفاقي بعض أولئك المخلصين الوطنيين، يقفون بباب الغرب وهو يأبى أن يفتح لهم..
فإما أن يكونوا جزءا منه هناك حيث يذوبون فيه،
وإما أن يكونوا أدوات لهيمنته وسيطرته على نحو ما تفعل الأنظمة الحاكمة: تحرس مصالح الغرب وتحرس بقاء بلادها في التخلف!
الدساتير مجرد حبر على روق!
تعيس تونس الذي انفرد بالسلطة وتفاجأ باستسلام حركة النهضة، في واحد من أغرب انقلابات السياسة، يقول بأنه سيعدل الدستور وسيغير طبيعة النظام!!
وهكذا يرى الناس جميعا أن الاستسلام لا يسبب الإحراج، ولا يسحب الذرائع، ولا يزيل الشمّاعات.. المسار واحد!
أتذكر بالأسى والألم أن الغنوشي تنازل في سبيل هذا الدستور عن كل شيء، وكان يراه إنجازا عظيما يستحق كل تنازل!!
وله حلقة لا أنساها -مع أحمد منصور في برنامج بلا حدود، فبراير 2014- كانت نموذجا لبؤسه وتهافته!!
في تلك الحلقة كان كلما ضاق عليه الخناق قال: صنعنا دستورا لتونس!!
كأن الدستور يغفر ما تقدم من الخطأ وما تأخر!! وكأن الدستور يعصم من الانقلابات!! وكأن الدستور هو علامة نجاح الثورات!!
متى نعرف أن الدساتير مجرد حبر على روق! ملاحظة للأغبياء: هذا الكلام ليس تشفيا في النهضة ولا فرحا بما نزل بها، هذا الكلام أقوله منذ 2013..
ولو أني أحب المعايرة والتشفي لأتيتُ بنصوص ما كتبتُه حينها «ولربما أفعل لأفقأ عين الأغبياء الذين لا يتعظون أبدا»!
وحين يقع شيءٌ طالما حذرنا منه، فأولى الناس أن يتكلم هو من حذَّر ونبَّه، أما من جعل من نفسه ماكينة تبرير وتزوير..
فعليه أن يقعد مع نفسه ليندم أو ليعيد التفكير أو حتى ليتعلم، بدل أن يأتينا ليوزع مواعظه حول الوقت المناسب وخصوصية التجربة وبقية الكلام السخيف الذي لا نفع فيه.
«الناس على دين ملوكهم»
ربما حُلَّت نصف معضلات أفكاري في اليوم الذي أيقنت فيه أن «الناس على دين ملوكهم» لا أنهم «كما يكونوا يُولَّى عليهم».
أتذكر ذلك اليوم.. كان قبل عشرين سنة تقريبا.. ولم تأتِ هذه العشرين إلا بما يزيدني قناعة بهذا واستمساكا به.
فيما قبلها كانت الحيرة تضرب خيمتها في نفسي.. أين الخلل؟ ومن السبب؟ وكيف الحل؟!
ولستُ الآن بصدد التدليل على هذا أو سوق البراهين له.. لكن ثمة ملاحظة جديرة بالإشارة إليها!
رأيتُ الذين يضعون المسئولية عن الشعب، منصرفين عن معارك الأمة الكبرى، ممتنعين عن مجالدة الطغيان أو إنكار منكره، منصرفين إلى مجالدة الشعوب وسبها والطعن فيها، معركة سهلة لذيذة.. فليس هناك من اسمه «الشعب» لكي ينتفض دفاعا عن نفس وسمعته وردًّا على من يظلمه ويشتمه!
معركة سهلة لذيذة، يمكنك بعدها أن تنصرف إلى خاصة شأنك، ترى أنك فعلتَ ما عليك، وأنك أحسن من الناس، وأنهم لم يبلغوا أن يصلوا إلى مستوى عقلك وفهمك وثقافتك وأخلاقك وحكمتك البالغة!
فإذا حَشَرَكَ الزمان -رغم أنفك- في معركة بسيطة مع مجرم أو ظالم، وجدتَ في جعبتك من أدوات الحكمة ما يسمح لك بمجاملته والتلطف له ومداراته، وربما نفاقه بصريح العبارة وجميل النظم!
وترى بعد هذا أنه من الضرورات والاضطرارات والإكراهات التي يجوز معها ما لا يجوز.
فإذا كنتَ أيها الحكيم العاقل الخبير قد أجزتَ لنفسك نفاق الحاكم مضطرا، فلم لم تعذر بهذا الشعب؟ والشعب -كما تراه- جاهل ليس عنده علمك، ومنحط ليس عنده خلقك، وسفيه ليس عنده حكمتك، ومتبع لشهوته ليس عنده حلمك وتعففك!!
إن معركة الإصلاح في جوهرها معركة حكم وسلطة.. إلى الحكم والسلطة ترنو كل حركات الإصلاح والإفساد، فمن وصل إليها وغلب عليها ألزمَ الناسَ أفكارَه وأخلاقَه وطباعه!
ولذلك وجد كل نبيٍّ ملأً في وجهه، هم مَنْ تولَّوْا حربه ومواجهته والتضييق عليه، فإذا غلبهم اتبعه الناس، وإذا غلبوه هلكوا ومعهم الناس.
يقول قائل: ولكن الذين يحكموننا هم منا، من هذه الأرض، ويتكلمون بألسنتنا، ودرجوا من قبائلنا وعشائرنا!
وأقول: في عصر النظام العالمي، والدولة المركزية، والفجوة الكبيرة في التسلح بين السلطة والناس، لا بأس أبدا أن يُقال بأن هؤلاء الذين يحكموننا إنما نزلوا علينا من الجوّ، ووُضِعوا في مكانهم بغير إرادتنا ورغما عنا، ولكل طحين نخالة!
وكانت مهمة الاحتلال، ثم هذا النظام العالمي، أن يستخرج الأقليات ليُمَكِّنَها، أو يدعم من كان أكثر شرا وأعرق في الخيانة ليُنَصِّبَهم حُكَّامًا.
وها هي أمتنا تشهد وترى بنفسك.. كيف إذا غلب عليها حاكم فحركها للكفاح ضد الصهاينة -مثلا- اتبعوه وضربوا أمثلة في البسالة، وكيف إذا عليها من يسوقها للتطبيع وجد فيها نخالة تغني بالعبرية وتفلسف لجمال وحلاوة العلاقة مع الصهيونية وتتبرع بأرضها الخاصة لإقامة السفارة الإسرائيلية!! وبعضهم يزيد فيقول: وأنا أؤيد فتح سفارتين إسرائيليتين في بلدنا لا واحدة!
ألا صدق قول المتنبي في حالنا لا في حال زمنه:
سادات كل قبيل من نفوسهمُ .. وسادة المسلمين الأعبدُ القزمُ
واقعنا المعاصر هناك أمرٌ ما جوهري ومركزي في النظر إلى واقعنا المعاصر.. يترتب عليه اختلاف واسع!.. ذلك هو الآتي: إنه شيء طبيعي أن يختلف الناس حول ما إن كان الأفضل لهم ولحياتهم:
وجود سُلطة قوية محترفة ودقيقة تدير أمور المجتمع بما في ذلك سائر التفاصيل، وتحتكر لنفسها القوة! وذلك لتحقيق أعلى قدر من الكفاءة والنظام.
أو وجود سلطة ضعيفة في مجتمع قوي، يقتصر دورها على التدخل عند حدوث الخلل أو وقوع المشكلات، ومن ثم فهي لا تحتكر لنفسها القوة وإن كانت الطرف الأقوى بطبيعة الحال! وذلك هروبا من الاستبداد والطغيان ولتحقيق أعلى قدر من الكرامة الإنسانية.
هذا خلاف يمتد من الفلاسفة في أعلى هرم التفكير، وحتى الإنسان البسيط في أدغال الغابات وفي قعر البيت.. كلهم له وجهة نظر في دور السلطة الأمثل (حتى لو كانت سلطة الأب في البيت).
هذا النقاش لا أخوض فيه الآن..
ما أريد التركيز عليه هنا، أن هذا النقاش عديم الفائدة في واقعنا العربي والإسلامي المعاصر.. لسبب بسيط جدا جدا جدا..
وهو أن الدولة العربية المعاصرة لم تنشأ أساسا لتحقيق مصالح المجتمع، بل ولا هي كانت إفرازا طبيعيا لهذا المجتمع.. إن الدولة العربية المعاصرة -بكل بساطة- هي مجرد آلة استعمارية أنشأها الغرب وثبت وجودها بالقسر والعنف، وتعمل لتحقيق مصالح الغرب وتمويل آلته العسكرية وإخماد مقاومة الشعوب لهيمنته!
وهذا ليس كلام الإسلاميين وحدهم بل هو كلام آخرين من القوميين واليساريين وحتى من الغربيين أنفسهم، بل وينفلت التصريح به في مذكرات صناع القرار الغربيين وفي تقاريرهم لمكافحة “التمرد”.
المصيبة الحقيقية أن كثيرا من الإسلاميين، بما في ذلك كثير من علمائهم ومفكريهم، ابتلعتهم نظرية الدولة حتى أنهم يحسبون هذه الدولة المعاصرة مكافئة ونظيرا للدول الإسلامية كالأموية والعباسية والعثمانية.
فَهْمُ هذه الحقيقة البسيطة: الدولة العربية المعاصرة هي آلة احتلال تعمل بكفاءة في خدمة المحتل.. سيوفر كثيرا من الخلاف، وسينقلنا من آفاق الخلاف النظري حول الدولة ودورها والعلاقة بين السلطة والمجتمع، إلى الخلاف العملي الذي سيتركز ببساطة حول: كيفية تدمير آلة الاستعمار هذه!
كان الجويني قد فطن ببعد نظره إلى أن الفوضى خيرٌ من أن يحكم الناس رجل يستعمل سلطته في إفسادهم، فقال: “تَرْكُ الناس سدى ملتطمين لا جامع لهم على الحق والباطل، أجدى عليهم من تقريرهم على اتباع مَن هو عون الظالمين وملاذ الغاشمين وموئل الهاجمين”.
فإذا كان ذلك كلام رجل نشأ في ظل نظام المُلك الطوسي، أحد أقوى أمراء المسلمين، وفي ظل دولة غير حديثة ولا متغولة، ولا هي واقعة تحت هيمنة أجنبية غير مسلمة، إذا كان ذلك كذلك.. فكيف يمكن التفكير في الدول العربية المعاصرة باعتبارها سلطات مسلمة تقوم مقام أولياء الأمور الذين يحفظون الدين ويجاهدون العدو ويقيمون مصالح المسلمين؟!
إن النقاش العملي الواقعي في زماننا هذا لا يتعلق بفلسفة الدولة والسلطة والمجتمع بقدر ما يتعلق بواقع نكبتنا الساطعة.
فلو أنه لم يوجد في بلادنا خونة منافقون، لرأيتَ المسلم والكافر، ورأيتَ الإسلامي والليبرالي والشيوعي والجميع متفقون حول ضرورة تعطيل هذه الآلة الاستعمارية التي تُسَمَّى دولة! لأنها ضدهم وضد وجودهم وضد مصلحتهم على طول الخط. واستمرارها يعني استمرار الضعف والنكبة والذلة للأجنبي!
ثم إذا هم انتصرت ثورتهم على هذه الدولة، اختلفوا -أو حتى تقاتلوا- فيما بعد حول الدولة المنشودة، ما بين من يريدها سلطة قوية محترفة في مجتمع ضعيف تحتكر وسائل القوة لتدير له مصالحه بكفاءة، وبين من يريدها سلطة وازنة هي أقوى الأطراف لكنها لا تحتكر القوة فوق مجتمع متشبع بالتكتل لتحقيق أعلى قدر من الأمن والكرامة!
إذا صدقت النوايا، فالحوار حول فلسفة الدولة وعلاقة السلطة بالمجتمع، هي في بلادنا، حوار مؤجل.
القدوات في زمن الهزائم
كان من حُسْن حظ العقاد -كما قال ذلك في مذكراته- أن بداية عمله في الصحافة كانت في صحيفة يصدرها الأستاذ “محمد فريد وجدي”، وهو اسم معروف في عالم الفكر والصحافة في مطلع القرن العشرين. يقول العقاد بأن فريد وجدي كان مثالا في الصدق والنزاهة والوطنية، وفي التمسك بالحق الذي يعتقده، وأنه لهذا اضطر فيما بعد لإيقاف الصحيفة عن الصدور رغم العروض المغرية التي عُرِضَت عليه، من جماعة “تركيا الفتاة” لتكون هذه الصحيفة لسان حالها في مصر، أو من الخديوي نفسه.. إلا أنه أبى أن يكون ناطقا بلسان أحد وأن يتهدد استقلاله. أغلق الصحيفة، وباع مكتبته الشخصية ليسدد أجر كل عامل في الصحيفة مليما بمليم، ولا ينقص من حقوقهم شيئا. تذكرتُ هذا الموقف، لأني كثيرا ما ألقى شبابا من اللاجئين في اسطنبول، من سائر البلاد العربية، وهذه شريحة جريحة، يكاد ألا يكون لدى واحد منهم معاناة كبيرة، فمنهم من وصل بعد رحلة مطاردة وخطر، ومنهم من تحمل ذاكرته مقتل أخيه أو أبيه أو صديقه، ومنهم من هُدِمت بلده ونُهِبت داره، ومنهم من لا يزال غير آمن على أهله وقد فرَّقت الأوضاع بينهم!
على أني حين أستمع إليهم أشعر أن الجرح الأكبر الذي أصابهم إنما هو “انهيار القدوة”..
هذا الزلزال الكبير الذي أصاب بلادنا العربية، تمكن به الكثيرون من معايشة حال “الرموز والقدوات” التي كانوا قبل ذلك يفدونها بأرواحهم غير مترددين، ثم اطلع منهم فيما بعد هذا على أمور صُدِم بها، أهون هذه الأمور أن هذا الرمز لم يكن على نحو ما تصور من الكفاءة حتى إنه لا يصلح لإدارة شأن صغير بينما كان يتخذ قرارات ضخمة في مواقع حساسة، وأسوأ هذه الأمور ما وقع فيه بعضهم من فساد مالي أو أخلاقي أو نحو ذلك.
انهيار القدوة ليس شيئا هينا، ذلك أن المرء إذا لم يجد الفكرة متمثلة في أشخاص، فإن الشيطان يذهب به إلى ازدراء الفكرة نفسها، وإلى انتقاص المثال نفسه.. فغالبا ما يقترن انهيار القدوة بانهيار الفكرة كلها، وقليلٌ من الناس من يصمد ويفكر ويميز، إن الصدمة والغضب والمفاجأة تسرقه عن تذكر الأمثلة الحية الصالحة التي رآها ليتضخم في وعيه وضميره هذه الأمثلة التي انهارت.
وفي هذا المقام أود أن أقول أمورا مختصرة:
1- في زمن الهزائم يخرج أسوأ ما في الناس، هذا من طبائع الناس، ولا يصمد في هذه المحن إلا الأفذاذ الكبار، وهم ندرة بين الناس. لهذا فيجب أن نعلم أن ما نراه من الناس في زمن المحنة ليست طبيعتهم السوية. 2- علينا أن نكثر الدعاء لأنفسنا ولإخواننا أن يثبتنا الله على ما يرضاه حتى نلقاه، فما من أحد إلا وفي نفسه من أمراض القلوب ومن الذنوب ما يمكن أن يخذله الله به ويفضحه به بين الناس. 3- ينبغي على من يسر الله سبيلا للعلم والتربية والإعلام والمال والعلاقات أن يجتهد ليُظهر للناس خير ما في الناس، فكم من أهل فضل وصلاح وخير لا يُعرفون ولا يُستفاد منهم، ما بينهم وبين هذا إلا أن يُعرف الناس به إعلامي ما، أو يُمَكِّنه من التدريس والتربية صاحب علاقات أو صاحب أموال، أو أن يشير إلى متبوع معروف مشهور فيفتح للناس هذا الباب المغلق من الخير.. وليس كل الناس يحب -أو حتى يجيد- أن يُعَرِّف بنفسه أو ينهض بنفسه لموهبته، فقد وزع الله المواهب والطاقات. من أنفسكم!
لعلها شهادة حان وقتها:
منذ وصلت إلى تركيا، وجمعتني لقاءات عديدة بمسئولين أتراك، منهم من كان نائبا لأردوغان، ومنهم المستشار الأول لداود أوغلو، ومنهم مدير مركز البحث الرئيس التابع للعدالة والتنمية، ومنهم نواب في البرلمان، وهذا بخلاف الإعلاميين والباحثين وأساتذة الجامعات الذين التقيت بهم في مؤتمرات أو ندوات علمية أو غيره.
وأقول:
لم أترك واحدا من هؤلاء إلا وسألته عن «احتمالية أن يقوم الجيش في تركيا بالانقلاب على أردوغان»، وعن «مدى سيطرة أردوغان على الجيش التركي».
وهؤلاء على اختلاف اتجاهاتهم وأفكارهم كانت لهم إجابة واحدة: الانقلاب ممكن جدا، وأردوغان ليس مسيطرا على الجيش بالقدر الذي أجزم به ألا يحدث انقلاب، وأي إنسان في تركيا يحدثك عن سيطرة كاملة لأردوغان فاعلم أنه لا يعرف شيئا!
بل أتذكر كأنني الآن كلمة مسئول تركي في جلسة خاصة، دار فيها الكلام عن المصالحة المصرية التركية قبل شهور، وسألته ضمن أمور كثيرة عن وضع المهاجرين، فقال: طالما «إخوانكم» موجودون في الحكم فأستطيع أن أضمن لك تماما أن المهاجرين لن يمسهم سوء، ولكن إذا حدث انقلاب عسكري غدا فأنا شخصيا لن أضمن حياتي!
ما المقصود من كل هذا الآن؟
المقصود منه أن القوم بعد 14 سنة في الحكم كانوا يعرفون حقا مدى قوتهم ومدى قوة خصمهم، ويعرفون مدى احتمال المخاطر.. لم تغرهم جلسات الود والسمر مع العسكر، ولا ضرب التحية العسكرية، ولا الحديث الدائم عن احترام الديمقراطية ولا.. ولا.. ولا… إلخ!
القوم يقظون لموقعهم ومدى تمكنهم من الأمور، فيعملون ما استطاعوا ولا يجدون حرجا في الاعتراف بأمر لم يستطيعوه بعد!
كان الكلام رغم ما يثيره من قلق يعجبني ويزيدني لهم احتراما، ويذكرني بالحسرة على “إخوانا اللي فوق” الذين لعب بهم العسكر الكرة وهم لم يكملوا شهورا في الحكم، وكل المؤشرات تدل على الخيانة، فضلا عن التاريخ المرير، وفضلا عن الحوادث الفارقة كأيام الاتحادية!
لم أقابل قياديا إخوانيا في مصر قبل الانقلاب إلا وطمأنني من ناحية الجيش، وكل هذا في لقاءات خاصة (يعني ليس فيها شبهة دبلوماسية ولا مناورة) بداية من خيرت الشاطر ومن تحته، ومن عاملين في الرئاسة ومن أعضاء مكتب إرشاد وغيرهم!
أبدا لم يعبر أحد عن خوفه من العسكر.. أبدا.. لا أدري، كأن السيسي سحرهم فعلا!
وأبأس من هذا ما وقع بعد الانقلاب، وما وقع بعد رابعة، إن ما رأيته بعيني وما سمعته بأذني يحملني حملا على الاعتقاد بأنهم مخترقون أكثر من كونهم مغفلين.. إن بعض هؤلاء يبذل جهده في تمكين العسكر، ويلعب به شاب من مركز بحثي غربي أو صحافي أجنبي أو غيره.
على كل حال.. قصدت أن أقول:
إن من حكم تركيا 14 سنة كان يعرف أن العسكر غير مأمونين رغم تلال الأدلة والمظاهر التي تقول بأن الوضع اختلف وتمكن لأردوغان، وأن من توهم أنه يحكم مصر لم يكمل شهورا حتى كانت ثقته في مدير مخابرات العسكر أكبر من ثقته في أخيه، بل لقد رمى أخاه البصير بأنه الوحيد الذي لديه هواجس ووساوس انقلاب عسكري!!
وصدق ربنا: ((وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير)).