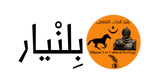التشريع الإسلامي بين المطلق و النسبي

تقديم
طرحت التطورات الفكرية و الحياتية التي شهدتها البشرية في القرن الماضي تحديات كثيرة أمام الفكر الإسلامي و المشتغلين به ، و انطلقت على ضوئها مراجعات و قدمت أطروحات سعت في أغلبها إلى الإجابة على الأسئلة التي أفرزتها هذه التحديات ، و اختلفت الزوايا التي نظر بواسطتها أهل العلم و الفكر إلى هذه الأسئلة بل اختلفت المنهجية في التعاطي ، ففريق اهتم بتقديم الفتاوى مجزأة حسب الأقضية التي تستجد أو الأسئلة التي تطرح أو الإكراهات التي تفرض نفسها و كان من هذا الفريق أفراد و مؤسسات و اشتهرت في هذا الصدد مواضيع في الطب و الأحوال الشخصية و المسائل المالية و المستجدات العلمية.
و فريق آخر اهتم بالنظر الكلي في الموضوع و اعتبر أن حجم التحدي الفكري أكبر و أوسع و أكثر تعقيدا و أوسع أثرا من التعامل معه بالطريقة الإفتائية التقليدية و يتطلب إبداع منهجية متكاملة.
و هكذا بدأ الاستدعاء ، استدعاء العلوم التاريخية عند المسلمين التي تساعد في هذه المهمة العلمية و المنهجية ، تذكروا أن الفقه الاسلامي تعايش مع أحوال و ظروف و سياقات متباينة فكيف و تكيف ” و لا عجب أن دخل هذا الفقه شتى البيئات و الأوطان ، و حكم مختلف الأجناس و الألوان ، من أعراب البوادي إلى ورثة الحضارات العريقة في بلاد الأكاسرة و القياصرة و الفراعنة و التبابعة ، و قد واجه نظما متباينة و عادات متضاربة و أفكارا متباعدة و أوضاعا متغيرة و أحوالا متقلبة ، فلم يضق ذرعا بالإفتاء فيها ، و التشريع لها ، و القضاء بينها بالقول الفصل و الحكم العدل ” (1) و هي الشهادة نفسها التي قدمها باحث من نوع آخر هو الدكتور وائل حلاق الذي يقول متحدثا عن تعددية الفقه ” فقد زودته بقدر كبير من المرونة و القدرة على التكيف في إدارة مجتمعات و أقاليم مختلفة جذريا من المغرب إلى أرخبيل الملايو ، و من بلاد ما وراء النهر سيحون إلى الصومال ” (2).
و طبيعي أن يكون التركيز على علم أصول الفقه الذي اعتبر من قبل كثيرمن الدارسين في الحقل الإسلامي و من خارجه التطور المنهجي الأبرز في تاريخ النظر عند المسلمين ، و معروف أن هذا العلم تطور على نحو واسع من عهد الإمام محمد بن إدريس الشافعي في كتابه ” الرسالة ” الذي يعتبر باكورة التأليف في هذا العلم إلى تبلور ” المقاصد ” مع أبي إسحاق الشاطبي(3) بكل ما تضمنته من سعة منهجية و تركيبية أعطت للعقل الإسلامي مجالا و أمدا واسعين.
محاضرة: علم مقاصد الشريعة من الولادة الكامنة إلى الولادة الكاملة للدُّكتور أحمد الريسوني و هكذا ستفيد المدونة الأصولية مدرسة البحث عن منهجية متكاملة للإجتهاد الإسلامي المعاصر ، و هنا سيبدأ النظر للتشريع الإسلامي بمعناه العام في استحضار ثنائية المطلق و النسبي التي تهدف لوضع الحدود دائرتيها ، دائرة المطلق الذي يتجاوز الزمان و المكان فلا يتأثر بتقلب العصور و لا باختلاف الأمصار و دائرة النسبي التي يختلف التعاطي معها من حال إلى حال و من فترة إلى أخرى و تصطبغ بعوائد و أعراف و خصوصيات الأمم و الشعوب، وقد صاغ الدكتور حسن الترابي هذه الثنائية بلغته الخاصة ” و الحق في تصور الدين أنه توحيد بين شأن الله و شأن الإنسان في الدنيا ، بين المطلق الثابت و النسبي المتحول ، و يكمن البلاء المبين في المفارقة الدائبة التي تطرأ بين الحق الأزلي و القدر الزمني و يكمن الموقف الديني في التزام التكليف الشرعي بمجاهدة تلك المفارقة حيثما طرأت و محاولة تحقيق التوحيد في كل حال ” (4).
و نحن إذ نقدم على طرح هذه الإشكالية أو هذه الثنائية فلأن وضوح النظر في شأنها و ضبط القواعد في التعامل معها عاصم منهجي في بلورة الرؤى و تحديد الاختيارات ، فمما يربك أي مسار نظري أو بناء فكري هو غياب الأرضية التي تحكمه فيؤدي ذلك إلى اضطراب في التوجهات و التقريرات التي قد تعتبر أمرا في حال و تناقضه في آخر ، تسمح بمرونة في قضية ثم تضيق في أخرى و في الغالب يتأثر بهوى اللحظة أو ضغط الحال أو إكراه المجال.
و سنجتهد في هذه الورقة في تناول هذا الموضوع من خلال منطلقات و ضوابط تتحدد على ضوئها فلسفة الفهم و حدود الثوابت و مجال المتغيرات و ترسم بناء عليها طبيعة العلاقة بين الديني و الدنيوي و ما يترتب على ذلك من اختيارات و خلاصات ستحكم المحور الثاني الذي سنحاول فيه تنزيل هذه المعاني الفكرية و المنهجية على الفقه السياسي أو الفكر السياسي متوقفين عند خصوصيته مارين على أثر العنصر الزمني و التجارب السابقة عند المسلمين و علاقة الوحي و التاريخ في ذلك السياق خالصين إلى جملة من الخلاصات اعتبرناها بمثابة مقاربة في الفقه السياسي و منتهين إلى فتح آفاق لبحث ينبغي أن يتواصل و يتطور .
أولا : منطلقات و ضوابط
نسعى من خلال هذه الضوابط أو هذه المنطلقات إلى تصور رؤية متكاملة عن فهم المنظومة الاسلامية تكون وسيلة لحد الحدود بين المطلق و النسبي في هذه المنظومة ، و مع إدراكنا للصعوبات أمام ذلك نظرا للتداخل الذي وقع زمنا طويلا بينهما و الاحتماء الذي لجأت إليه مدارس إسلامية عديدة بالمقدس و المطلق حتى تضفي على اختياراتها واجتهاداتها صفة الحق الثابت و بالتالي صبغ مخالفيها بعكسه ، مع ذلك سنجتهد لبناء هذه الرؤية معتمدين على بعض مخرجات مدرسة ” الأصول ” في بعض تجلياتها .
في قواعد الفهم
لعل الإمام أبا حامد الغزالي يساعدنا حين يضع ضابطا مهما للتعامل مع الشرع و نصوصه خصوصا في مجاله العام و الذي سيسميه الشاطبي ” العادات ” يقول أبو حامد الغزالي موصيا الفقيه المجتهد بأن : ” يكون شديد البحث عن أسرار الأعمال و الأقوال ، فإنه إن اكتفى بحفظ ما يقال كان وعاء للعلم و لا يكون عالما و لذلك يقال فلان من أوعية العلم فلا يسمى عالما إذا كان شأنه الحفظ من غير اطلاع على الحكم و الأسرار ” (5)
و سيكون هذا الاهتمام بالأسرار و عدم الاكتفاء بالحرف و الظواهر دافعا للبحث عن العلل و المقاصد ، يقول عضد الدين الإيجي : ” و التعليل هو الغالب على أحكام الشرع ، و ذلك لأن تعقل المعنى و معرفة أنه مفض إلى مصلحة أقرب إلى الانقياد من التعبد المحض ، فيكون أفضى إلى غرض الحكيم ” (6) و يؤكد المقاصدي التونسي العلامة محمد الطاهر بن عاشور نفس المعنى : ” و استقراء أدلة كثيرة من القرأن و السنة الصحيحة يوجب لنا اليقين بأن أحكام الشريعة الإسلامية منوطة بحكم و علل راجعة للصلاح العام للمجتمع و الأفراد ” (7).
كتاب مقاصد الشّريعة الإسلامية للطاهر بن عاشور إن ربط النصوص بالحكم و ربط الأحكام بالعلل يعطي منظومة تفسيرية من شأنها أن تبعدنا عن النظرة الظاهرية التي لا تلفت إلى المعاني و تلتزم بالأشكال حتى و لو لم تعد محققة للقصد و قد أكد عالم المقاصد الأشهر أبو إسحاق الشاطبي أن ” الأصل في العبادات بالنسبة للمكلف التعبد ، دون الالتفات إلى المعاني ، و أصل العادات الالتفات إلى المعاني ” (8).
و قد وفق الدكتور حسن الترابي في أطروحته التجديدية في صياغة الأمر على نحو دقيق عندما قال : ” و من أعسر قضايا فقه الدين إدراك ما هو مقصود بغايته و صورته أيضا – بالنية و الشكل معا – من مظاهر التدين التي جاء بها النموذج الشرعي عهد نزول القرآن و حياة الرسول صلى الله عليه و سلم ، و ما جاءت فيه الصورة عرضا غير مشروطة بذاتها على التأبيد بل لكونها وسيلة التعبير المتاحة في تلك البيئة الأولى عن مقصود الشرع ” (9)
و قد استطاع بعض الباحثين من خلال استقراء جيد لأطروحات أبي إسحاق الشاطبي أن يحدد قواعد أو ضوابط للفهم تشكل مجتمعة ما يمكن اعتباره نظرية أصولية في فهم نصوص الشرع ، فقد شرح الدكتور عبد المجيد اسماعيل السوسوه ذلك في بحثه القيم ” الأسس العامة لفهم النص الشرعي: دراسة أصولية ” اعتمد فيه طبعا على صاحب الموافقات و اعتبر هذه الأسس ثلاثة (10) الأساس الأول : الضبط اللغوي للنص و وضعه في موضعه ، الأساس الثاني : التكامل الدلالي بين النص و غيره مما له أثر على دلالته ، الأساس الثالث : الإهتداء بالمقاصد في فهم النص .
و اعتبر الدكتور عبد المجيد النجار الضابط الظرفي المستحضر لأسباب النزول أو الورود مستقلا بذاته مكملا للأسس الأخرى (11) و لا يعتبر ما سبقت الإشارة إليه من التفات إلى المعاني و المقاصد و ربط للأحكام بعللها أمرا جديدا بل شهدت حياة النبي صلى الله عليه و سلم و الصحابة الكرام ما يمثل أساسا لكل هذه المعاني : ففي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عندما رخص صلى الله عليه و سلم للشيخ و لم يفعل للشاب في التقبيل أثناء الصيام و استغرب الحاضرون قال صلى الله عليه و سلم : ” إن الشيخ يملك نفسه ” (12) و في ادخار الأضحية من عدمه علله صلى الله عليه و سلم بعد المنع ثم الإذن : ” إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت ” أو ” فإن ذلك العام كان بالناس جهد – أي شدة و أزمة – فأردت أن تعينوا فيها ” (13) و حديث القبور مشهور ” كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، ألا فزوروها ” و أوضح الإمام القرطبي أن هذا الأمر ليس من باب النسخ بل من باب ارتفاع العلة ” بل هو حكم ارتفع لارتفاع علته ، لا لأنه منسوخ …… فلو قدم على أهل بلدة ناس محتاجون في زمان الأضاحي و لم يكن عند أهل ذلك البلد سعة يسدون بها فاقتهم إلا الضحايا لتعين عليهم ألا يدخروها فوق ثلاث كما فعل النبي صلى الله عليه و سلم ” (14) و معروف هو تغير فتاوى الصحابة في جملة من القضايا : في الأنواع التي تخرج منها زكاة الفطر ، و في زكاة الخيل ، و في سهم المؤلفة قلوبهم ، و في قسمة الأرض المفتوحة ، و في عام المجاعة ، و في جمع القرآن ، و في توبة القاتل ، و في التقاط الضالة (15) .
مقاصد الشريعة: د. عبد المجيد النّجّار و قد سادت في تاريخ المسلمين مدارس تحفظت و لم تتوسع في هذا الاتجاه بل مالت إلى الاحتياط و منع التأويل ، و قابلتها مدارس الرأي و التعليل حتى شكا أبو سليمان الخطابي من انقسام الناس في عصره : ” إلى فرقتين : أصحاب حديث و أثر ولى أكثرهم ظهره للفقه و الفهم ، و أصحاب فقه و نظر لا يعرج أكثرهم من الحديث إلا على أقله ” (16).
و تعتبر قضية المصالح و اعتبارها من أهم الأمور التي ساعدت في بناء التصور المشار إليه في مفتتح الحديث ، افتتح الإمام الشاطبي كتاب المقاصد من الموافقات قائلا : ” و لنقدم قبل الشروع في المطلوب مقدمة كلامية مسلمة في هذا الموضوع ، و هي أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل و الآجل معا ” (17) و حين ذكر أقسام المقاصد ربط الضرورية بهذا المعنى ” فأما الضرورية فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين و الدنيا ، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد و تهارج ” (18).
ثم أوضح أن مقاصد الشرع في اعتبار المصالح مبثوثة مضطردة في التشريع شاملة له ” مقاصد الشرع في بث المصالح في التشريع أن تكون مطلقة عامة ، لا تختص بباب دون باب ، و لا بمحل دون محل ، و لا بمحل وفاق دون محل خلاف ، و بالجملة الأمر في المصالح مطرد مطلقا في كليات الشريعة و جزئياتها ” (19) و قد أكد تلميذ الشاطبي ابن عاشور نفس المعنى مع لفتة مفيدة جديدة ” فالشرائع كلها – و بخاصة شريعة الاسلام – جاءت لما فيه صلاح البشر في العاجل و الآجل ، أي في حاضر الأمور و عواقبها ” ثم يوضح ” و ليس المراد بالآجل أمور الآخرة ، لأن الشرائع لا تحدد للناس سيرهم في الآخرة ، و لكن الآخرة جعلها الله جزاء على الأحوال التي كانوا عليها في الدنيا ” (20).
و لكن العلامة العز بن عبد السلام أوضح الأمر أكثر و أعطاه مقاربة شاملة ستفيد أكثر في زوايا النظر للمصالح ببعديها الديني و الدنيوي : ” أما مصالح الآخرة و أسبابها و مفاسدها و أسبابها ، فلا تعرف إلا بالشرع ، فإن خفي منها شيئ طلب من أدلة الشرع ، و هي الكتاب و السنة و الإجماع و القياس المعتبر و الاستدلال الصحيح ، و أما مصالح الدنيا و أسبابها و مفاسدها و أسبابها فمعروفة بالضرورات و التجارب و العادات و الظنون المعتبرات ، فإن خفي شيئ من ذلك طلب من أدلته ” ( 21) و قد اعتبر الصحابة رضوان الله عليهم و هم الأفقه و الأفهم المصالح هذه ، فالمصلحة هي التي جعلت أبابكر رضي الله عنه يجمع الصحف المفرقة التي كان يدون فيها القرآن ، و المصلحة هي التي دفعت عمر رضي الله عنه لوضع الخراج و تدوين الدواوين ، و هي التي جعلت عليا رضي الله عنه يضمن الصناع و يأمر أبا الأسود الدؤلي بوضع مبادئ النحو و هي التي استند إليها معاذ بن جبل رضي الله عنه في أخذ الثياب اليمنية بدل العين من زكاة الحبوب (22).
و يأتي الاجتهاد باعتباره الآلية الشرعية لتنزيل المعاني السابقة في إطار يجيب على الأسئلة و يعالج ما استجد من أقضية و أحوال ، يوضح الإمام الشاطبي معنى العموم و الكلية الذي يشكل أرضية الاجتهاد ” و يكفيك من ذلك أن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتها ، و إنما أتت بأمور كلية و عبارات مطلقة تتناول أعدادا لا تنحصر ” (23) و قد كان حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم المروي في الصحيحين ” إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، و إذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ” تشجيعا صريحا و تشريعا لا يقبل التشكيك يقول الدكتور أحمد الريسوني معلقا على هذا الحديث : ” لقد كان من الممكن ذهنيا و قياسيا أن يكون للمجتهد المصيب أجر ، و أن يكون على المجتهد المخطئ وزر.
و كان من الممكن أيضا أن يكون المجتهد المخطئ معفوا عنه بلا أجر و لا وزر ، و في هذا عدل و فضل ، أما أن يكون المجتهد المخطئ غانما مأجورا فهذه هي الحكمة البالغة و الرحمة السابغة ” (24) و في كتابه القيم ” تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع ” أوضح العلامة عبد الله بن بيه أبعاد هذه المسألة و تنزيلاتها المختلفة ، و يتأسس الاجتهاد على حقيقة شرعية بينة أوضحها الحديث الشريف ” ما أحل الله في كتابه فهو حلال ، و ما حرم فهو حرام ، و ما سكت عنه فهو عفو ، فاقبلوا من الله عافيته ، فإن الله لم يكن لينسى شيئا “(25) و مع ذلك فالاجتهاد ليس بابا مفتوحا دون ضوابط و لا موجهات ، صحيح أنه أحيانا و في بعض مراحل تاريخ المسلمين عسرت شروطه و ساد الاحتياط الزائد ، و لكن الاجتهاد مع ذلك يتطلب علما و معرفة و أدوات و لذلك حذر د. أحمد الريسوني ” فهل يعقل و يقبل أن يكون الدين وحده – بأصوله و فروعه و قواعده – مجالا مباحا يقول فيه من شاء ما شاء بدعوى حرية الفكر و عدم احتكار الحقيقة ” (26).
و تستمر الإضاءات المكملة للمعاني السابقة في التبلور داخل المنظومة الفقهية و الأصولية عند المسلمين ، فهذا الفقيه الحنفي المشهور ابن عابدين يعطي للزمان اعتباره و للعرف قيده ” فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان ، لتغير عرف أهله أو لحدوث ضرورة أو لفساد أهل الزمان بحيث لو بقي الخكم على ما كان عليه أولا للزم منه المشقة و الضرر بالناس و لخالف قواعد الشريعة ” (27).
و قد صاغ الإمام ابن القيم قاعدة مشهورة بالغة الدلالة في هذا السياق ” فصل : في تغير الفتوى و اختلافها بحسب تغير الأزمنة و الأمكنة و الأحوال و النيات و العوائد ” (28) و مآلات الأمور و النظر في المصائر و استحضار ذلك عنصر مهم يلزم حضوره عند الفهم و أثناء الصياغة و عند التنزيل لأن الأمور بمآلاتها ، لنستمع للإمام الشاطبي ” النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا ، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة.
و ذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل ” (29) و لشيخ الاسلام ابن تيمية موقف مشهور عكس هذا المعنى عندما أنكر على أصحابه إنكارهم على التتار شرب الخمر مبررا ذلك بأنها تشغلهم عن قتل الأنفس و ليس عن ذكر الله ، و قد اعتبر ابن القيم أن فقه المسافة بين الفهم و التنزيل فقه دقيق فهو ” موضع مزلة أقدام ، و مضلة أفهام ، و هو مقام ضنك ، و معترك صعب ” (30) و الناظر لبعض الأحكام و دلالات التخفيف الذي يكون بالاسقاط و التنقيص و الإبدال و التقديم و التأخير و الترخيص و التغيير أو التيسيرو مسالكه ( تغليب الإباحة على التحريم ، إقرار الرخص في محالها ، تقديم الترغيب و التبشير ) سيزداد وضوح الأمر عنده و لذلك اشتهر عن بعضهم ” نحن قوم لا نعرف التساهل في الدين ، و لكن نعرف التيسير فيه ، و لا نعرف التشديد في الدين ، و لكن نعرف الاستمساك به ” (31).
ثانيا: في الثوابت و المتغيرات
بناء على ما سبق نستطيع تصور قاعدة أو قواعد تضبط دائرة الثوابت من ناحية و دائرة المتغيرات من ناحية أخرى ، يعتبر الإمام ابن القيم أن هذا الباب واسع يحتاج فقها و فهما إذ يقول ” و هذا باب واسع اشتبه فيه على كثير من الناس الأحكام الثابتة التي لا تتغير ، بالتعزيرات التابعة للمصالح وجودا و عدما ” (32).
و يفصل العلامة الدكتور يوسف القرضاوي الأمر تفصيلا كاد يستحق وصف ” الجامع المانع ” إذ يعتبر أن أحكام الشريعة ذات مستويين ” مستوى يمثل الثوابت و الدوام ، و هو ما يتعلق بالأسس و المبادئ و الأحكام التي لها صفة العموم ، و هو ما جاءت به النصوص القطعية الثبوت و الدلالة التي لا تختلف فيها الأفهام و لا تتعدد فيها الاجتهادات و لا يؤثر فيها تغير الزمان و المكان و الحال … و مستوى يمثل المرونة و التغير و هو ما يتعلق بتفصيل الأحكام في شؤون الحياة المختلفة و خصوصا ما يتعلق بالكيفيات و الإجراءات و نحوها و هذه قلما تأتي فيها نصوص قطعية بل إما أن يكون فيها نصوص محتملة أو تكون متروكة للإجتهاد ” (33).
دراسة في مقاصد الشريعة للإمام القرضاوي و تشكل قاعدة الاستثناء التي لا تخطئها العين في النصوص و الممارسات الشرعية أساسا مهما لفهم ثنائية الثوابت و المتغيرات و من أهم نماذجها استثناء الحالات ( إقامة الحد أثناء الغزو ) ، استثناء الأفراد ( حالة من أسلم بعد الاتفاقية في الحديبية ) ، استثناء الجماعات ( جماعة ثقيف التي اشترطت ) ، استثناء الأقاليم ( أهل إيلياء مثلا ) و يعطينا الإمام القرافي في أسلوب مميز دفعا بكلامه في الفرق الثامن و العشرين ” و لا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك ، بل ‘ذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك ، لا تجره على عرف بلدك و اسأله عن عرف بلده و أجره عليه و افته به دون عرف بلدك و المقرر في كتبك ، فهذا هو الحق الواضح ، و الجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين و جهل بمقاصد علماء المسلمين و السلف الماضين ” (34).
و يعزز ابن القيم ” و هذا محض الفقه و من أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف أعرافهم و عوائدهم و أزمنتهم و أمكنتهم و أحوالهم و قرائن أحوالهم فقد ضل و أضل ” (35) و هذا ما دعا الدكتور حسن الترابي إلى القول ” و الفقه إذا تراكمت نقوله الموروثة قد يغري الجيل الخالف إلى أن يقنع بماضيه و يستغني عن الاجتهاد و إعمال وظائف العقل الناقد المولد المركب للمفهومات الجديدة ” (36) و لذلك لا غرو و نحن نتحدث عن اضطراد ثنائية الثوابت و المتغيرات أن نلحظ الوجه التعددي الذي ظهر في تاريخ الفقه و الفهم عندنا فلا ” عجب ان اتسع صدر هذا الفقه الرحب لمتشدد كابن عمر و مترخص كابن عباس ، و لقياسي كأبي حنيفه و أثري كأحمد ، و ظاهري كداوود ، فرأينا مدرسة الرأي و مدرسة الحديث و الأثر و أهل الألفاظ و الظواهر و أهل المعاني والمقاصد و المتوسطين المعتدلين بين هؤلاء و أولئك “(37).
في موضوع الديني و الدنيوي :
هي عناوين تتداخل لترابط موضوعاتها و لتقارب مترتباتها و لكنها تتمايز بحثا و فكرة ، و موضوع الديني و الدنيوي لما له أثر على لاحق الورقة و تنزيلاتها و خلاصاتها مهم و جوهري ، لقد اشتهر بين الناس عامة و عند المهتمين خاصة حديث تأبير النخل الذي قال فيه صلى الله عليه و سلم بعد أن خرج النخل رديئا ” إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشئ من دينكم فخذوا به و إذا أمرتكم بشئ من رأيي فإنما أنا بشر ” (38) و حديث الإمام أحمد أكثر صراحة ” ما تقولون ، إن كان أمر دنياكم فشأنكم و إن كان أمر دينكم فإلي ” (39) و من أدعية النبي صلى الله عليه و سلم المشهورة ” …. و أصلح لي دنياي التي فيها معاشي و أصلح لي آخرتي التي إليها معادي ” (40) إذن هناك أساس شرعي عام لهذا التمايز ، و هو يحدد مجالين مختلفين و قد يتداخلان بل من الوارد أن يتأسس أحدهما على الآخر و أن يأخذ أحدهما من بركة و مرجعية الآخر و لكن التمايز قائم مع ذلك.
لنستمع لبعض العلماء و الأعلام و هم يوضحون ذلك فالعلامة ابن حزم يقول معلقا على حديث تأبير النخل “و أخبرا أنه صلى الله عليه و سلم أعلمنا أننا أعلم بما يصلحنا في دنيانا منه ، ففي هذا كان يشاور أصحابه ، و أخبرا أنه صلى الله عليه و سلم جعل أمر آخرتنا إليه ” (41) أما الإمام مسلم فقد بوب للحديث المذكور في شرحه ” وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى الله عليه و سلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي ” (42) و قد جاء في نهج البلاغة كلام منسوب لأمير المؤمنين علي ” الحكم لله و في الأرض حكام ، لابد للناس من أمير بر أو فاجر يضم الشعث و يجمع الأمر و يقسم الفيئ و يجاهد العدو و يأخذ من القوي للضعيف حتى يريح بر و يستراح من فاجر ” (43).
و يذهب الدكتور عبد الإله بلقزيز إلى أن التمايز بين الديني و السياسي جاء واضحا بعده (ص) بل و كان له حضورفي زمانه ” كان يمكن ملاحظته حتى في مشروعه كما تجلى في عهده (ص) فعقده التحالفات و إبرامه العهود مع غير المسلمين و إقامة نظام المدينة على مقتضى الأمة لا على مقتضى الملة بعض من علامات كثيرة على الوجه السياسي ” (44).
عبد الإله بلقزيز مؤرّخ وباحث مغربي و قريب من بلقزيز ما ذكره الشيخ راشد الغنوشي أن ” رسول الله صلى الله عليه و سلم قد اجتمعت في شخصه صفات النبوة كمبلغ عن ربه مثل سائر إخوانه الأنبياء إلى صفات القائد السياسي للجماعة التي اهتدت بهديه أو التي ارتضت الدخول في عهده و إن لم تكن على دينه ” (45) و يعلق الدكتور سلمان بن فهد العوده على حديث بريده ” …… فلا تنزلهم على حكم الله ، و لكن أنزلهم على حكمك …… ” (46) ” و في هذا الحديث تحديد لمناطق السياسة الشرعية العامة المصلحية التي لا تصح نسبتها لله ، و لا الحديث فيها باسم الدين و الإسلام ” (47).
و لابن الحداد كلام في السياق ، يقول ” و السياسة سياستان سياسة الدين و سياسة الدنيا ، فسياسة الدين ما أدى إلى قضاء الفرض و سياسة الدنيا ما أدى إلى عمارة الأرض ، و كلاهما يرجعان إلى العدل الذي به سلامة السلطان و عمارة البلدان ” (48) و كما رأينا سابقا يفرق الإمام العز بن عبد السلام بين مصالح الدنيا و الأخرى و طرق كل منهما.
و انتهى الدكتور سعد الدين العثماني إلى رأي “و في رأينا أن العلاقة الأوفق بين الدين و السياسة في الاسلام ليس هو الفصل القاطع ، و ليس هو الوصل و الدمج التامين ، بل هو وصل مع تمييز و تمايز ” (49) و لعل تحديد مهمة الدولة و السلطة يساعد في معرفة حدود التمايز.
يرى د. بلقزيز أن الدولة ” لا تبرر نفسها إلا بوظائفها المدنية الصرف في حفظ الأمن و التنمية و حرية المواطنين و حماية القوانين التي يتوافق عليها المواطنون ” (50) و هو نفس الرأي تقريبا للغنوشي ” أما الدولة فمهمتها تقديم الخدمة للناس قبل كل شيئ كمواطن الشغل و الصحة الجيدة و المدرسة الجيدة ” (51) و يتفنن عبد اللطيف الهرماسي في الصياغات (52) التي ترسم العلاقة بين الدين و الدنيا أو الدين و السياسة ” الديني و الدنيوي : تطابق أم تقاطب أم تداخل ” ” الديني و السياسي من التداخل إلى التمايز ” ” الدين و السياسة : نزاع الصلاحيات و تداخل الحقول ”.
الهوامش:
1 الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد، الدكتور يوسف القرضاوي، دار الصحوة للنشر ـ القاهرة 1986/ص 19.
2 الدولة المستحيلة: الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي، وائل حلاق، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط الأولى ـ بيروت 2014م/ ص 124.
3
4 تجديد الفكر الإسلامي، د. حسن الترابي، دار البعث ـ قسنطينة ـ الجزائر 1990/ ص 106.
5 إحياء علوم الدين، 1/94، أبو حامد الغزالي، دار الكتب العلمية ـ بيروت، بدون تاريخ.
6 شرح مختصر ابن الحاجب 2/ 238، عضد الدين الإيجي، ط2، دار الكتب العلمية ـ بيروت 1983م
7مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن عاشور، ط5، دار سحنون ـ تونس 2012م
8 الموافقات في أصول الشريعة الإسلامية،أبو إسحاق الشاطبي، تحقيق محمد الإسكندري وعدنان درويش/ ط1، دار الكتب العربي، بيروت 2002م،/ ص 107.
9 د حسن الترابي/ مرجع سابق / ص 107.
10الأسس العامة لفهم النص الشرعي، عبد المجيد السوسوة، دار الجامعات اليمنية، ط1، 2000م
11 فقه التدين فهما وتنزيلا، عبد المجيد النجار، الزيتونة للنشر والتوزيع، ط 2، 1995م.
12 رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
13 رواه البخاري
14 نسبها القرضاوي إلى القرطبي في تفسيره، ج12 ،ص47 -48 .عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية، دار الصحوة للنشر، القاهرة، ط2 ، ص 8
15 راجع: القرضاوي، المرجع السابق، وجاسر عودة، مقاصد الشريعة كفلسفة للتشريع الإسلامي: رؤية منظومية.
16 الصالح، محمد أديب، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط5 ،2008م، ص 349
17 الموافقات، مصدر سابق، ص 2
18 المصدر نفسه، ص 202
19 المصدر نفسه، ص 230
20 ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص 14
21 عبد العزيز بن عبد السالم، عزّ الدين، القواعد الكبرى الموسوم بـ (قواعد الأحكام في إصلاح الأنام)، دار القلم، دمشق، ط4 ،2010م، ص 13
22 راجع: عوامل السعة والمرونة، مرجع سابق، ص 20 -21
23 الموافقات، مصدر سابق، ص 726
24 الريسوني، أحمد، الاجتهاد: النص، الواقع، المصلحة، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط1 ،2012م، ص 10
25 رواه البزار ورجاله ثقات، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي .
26 الريسوني، أحمد، الاجتهاد، مرجع سابق، ص 15
27 مجموعة رسائل ابن عابدين، للعلامة محمد أمين افندي الشهير بابن عابدين، 2 /125
28 الجوزية، ابن قيّم، إعلام الموقعين عن ربّ العالمين، دار الحديث، القاهرة، ط 2006 ،المجلد الثاني، ص5
29 الموافقات، مصدر سابق، ص 773
30 الجوزية، ابن قيّم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، دار الفكر، بيروت، ط1 ،2005م، ص 17
31 ذكرها: الزير، عبد الله، من مرتكزات الخطاب الدعوي، سلسلة كتاب الأمّة، ط1 ،1997م، ص116
32 الجوزية، ابن القيّم، إغاثة اللهفان، المكتبة القيمة، مصر، 1973م، 1 /346 -349
33 القرضاوي، يوسف، بينات الحلّ الإسلامي، مكتبة وهبه، القاهرة، 1988م، ص 71 -74
34 القرافي، شهاب الدين، الفروق، المكتبة العصرية، بيروت، 2007م، ص 198
35 إعلام الموقعين، مصدر سابق، ص 78
36 تجديد الفكر الإسلامي، مرجع سابق، ص 138
37 عوامل السعة والمرونة، مرجع سابق، ص 47
38 مسلم كتاب الفضائل، باب امتثال ما يقوله شرعا، الحديث رقم: 4364
39 محمد ناصر الدين الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، مكتبة المعارف، سنة النشر: 1415 – 1995 حديث رقم 2225
40 مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من شر ما عمل، ومن شر ما لم يعمل، برقم 2720
41 ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، المكتبة العصرية، صيدا/ بيروت، ط1 ،2009م، المجلد الثاني، ص 187
42 النووي، محيي الدين، شرح صحيح مسلم، دار القلم، بيروت، ط1 (د.ت)، ج 15 ،ص 125
43 عبد الحميد بن أبي الحديد، أبو حامد، شرح نهج البلاغة، تحقيق محمد إبراهيم، دار الجبل، 1996م، ج2 ،ص 307
44 بلقزيز، عبد الإله، تكوين المجال السياسي الإسلامي: النبوّة والسياسة، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1 ،2005م، ص 201
45 الغنوشي، راشد، مقاربات في العلمانية والمجتمع المدني، المؤسّسة الإسلامية للطباعة والصحافة والنشر، بيروت، ط1 ،1999م، ص 119
46 الحديث أخرجه مسلم
47 العوده، سلمان بن فهد، أسئلة الثورة، مركز نماء للبحوث والدراسات، بيروت، ط1 ،2012م، ص 57
48 ابن الحداد، الجوهر النفيس في سياسة الرئيس، تحقيق رضوان السيّد، دار الطليعة، بيروت، ط1 ،1983م، ص 61 -62
49 العثماني، سعد الدين، الدين والسياسة: تمييز لا فصل، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط1 ،2009م، ص 112
50 الدين والدولة في الوطن العربي، ندوة لمركز دراسات الوحدة العربية، بالتعاون مع المعهد السويدي باالسكندرية، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1 ،2013م، ص 42
52 الدين والدولة في الوطن العربي، ندوة لمركز دراسات الوحدة العربية، بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1 ،2013م، ص 42